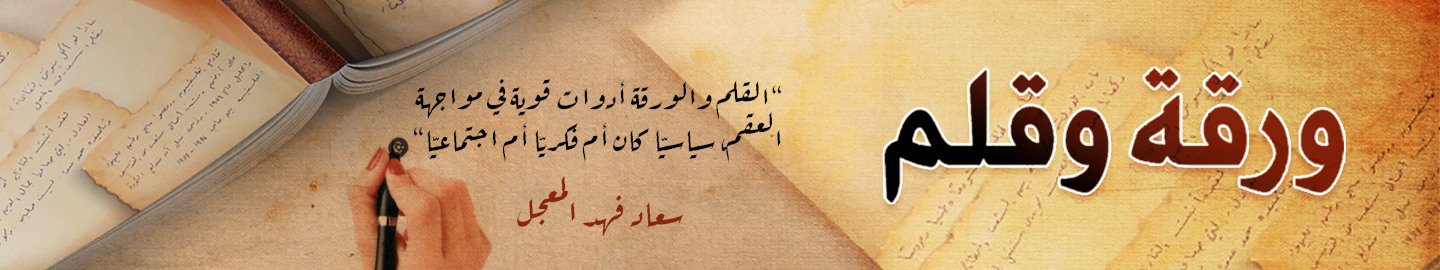العالم يعيش في ماتريكس

العالم يعيش في “ماتريكس”
ظهر فيلم “ماتريكس” في عام 1999، وشكّل ظهوره حينها نمطاً جديداً في السينما وأفكاراً مختلفة وغريبة آنذاك، لكننا اليوم، وفي ظل تداعيات التكنولوجيا، نستعيد تفاصيل ذلك الفيلم، التي تجعلنا في هذا الزمن متيقنين بأننا فعلاً نعيش داخل منظومة افتراضية تشبه إلى حد كبير الماتريكس أو القالب المصفوف.
في فيلم “ماتريكس” يجد “نيو” أحد قراصنة الكمبيوتر نفسه منضماً إلى مجموعة مقاوَمَة لم يكن يعرف بوجودها، وفي مواجهة نظام لم يكن يُدرك أنه مجرد مُستَعبَد فيه، ثم يعرض عليه الثوار فرصة الوصول إلى الاستنارة، لكن ذلك يشترط أولاً أن يُنكِر كل ما يعرفه عن العالم، ويُصبح فقط جزءاً من آلة ضخمة تتحكّم بها قوة قاهرة، قد تكون شركات تجارية أو دولة عميقة أو كمبيوتراً أو أي شيء آخر. خلاصة القول إنه لن يفلت من قبضة هذه القوة إلا إذا استطاع أن يُدرك وجودها.
بعض الذين شاهدوا فيلم “ماتريكس” منذ أكثر من عقدين تابعوا أحداثه كأي فيلم إثارة وتشويق بمؤثرات صوتية وتصويرية، لكن هنالك من رأى فيه أبعد بكثير من مجرد فيلم إثارة، حيث فتح الفيلم حينها جبهة النقاش بين مفكرين وفلاسفة استرسلوا في تقصّي الفكرة الرئيسية والمغزى الخفي من وراء هكذا فيلم، كان يحمل نبوءة يعيشها العالم اليوم بالتفصيل، حيث تقول الفكرة الخفيّة وراء الفيلم إن كل إنسان بالإمكان اضطهاده في عالم خفي لم يصنعه هو ولا يُمكنه رؤيته، لكنه سيبقى سجين هذا العالم ورهن الغشاوة والقناع الذي يضعه على عينيه لا إرادياً، ليُصبح بذلك أعمى تماماً عن الحقيقة هنا، التي تشير إلى أنه في سجن لم يصنعه ولا يُدرك أبعاده ولا يراه.
اليوم تتحقّق نبوءة فيلم “ماتريكس” أو القوالب المصفوفة، حيث اختفى التميّز وأصبح الناس يشبه بعضهم بعضاً إلى حد التطابق، ليس في الملبس وحسب، بل في الذوق والتصرّف والاختيار والسلوك الاجتماعي والتفكير والهيئة والتوجّه وكل شيء، حتى أصبحنا نسخاً مكررة في قوالب جاهزة للإطلاق داخل مجتمعات يقودها التقليد لا التفرّد، والتشابه في كل شيء لا التميّز.
أصبح العالم يعيش اليوم في قوالب مصفوفة بدقة تُديرها مؤسسات محترفة إعلامياً وتجارياً وسياسياً، بل حتى الحقائق لم تعد خاضعة لمعايير التقييم العقلاني بقدر ما أصبحت اليوم خاضعة للآلة الضخمة، التي تتحكّم بهذه المصفوفة أو الماتريكس، وبحيث اختفت هنا أي أفكار أو رؤى بديلة، فالجميع خاضع للقوة الوهمية المستترة خلف مسميات كثيرة، من إعلام إلى إعلان ومؤثّرين ومدربي حياة، وشركات تقذف بسلع استهلاكية يتلقّفها الناس من داخل المصفوفة أو الماتريكس من دون شعور أو إرادة، أو حتى ردة فعل ذاتية أو شخصية وفردية.
عالم مخيف مُسيّر بآلات تحرّك كل شيء في الإنسان، بما في ذلك مشاعره وذوقه وأحاسيسه، عالم مرسوم بدقة يسوده الوهم الذي هو أقرب إلى الوهم الذي عاشت فيه شخوص كهف أفلاطون، الذين توهّموا بأن ما يرونه من صور وأشباح يشكّل الحقيقة الوحيدة للعالم خارج كهفهم.
العالم بأسره يعيش اليوم تحقّق نبوءة فيلم “ماتريكس”، الذي قدّم الناس كقطعان من الغنم عليها أن تستيقظ. وعلى الرغم من مرور أكثر من عقدين على هذا الفيلم، فإن واقع اليوم أعاده إلى الذاكرة مع الفرضية التي وردت في الفيلم، والتي تقول إن الأغلبية العظمى من الناس كانوا دمى غير واعية في عالم تحكمه سراً الكائنات الفضائية، التي لا يراها الناس، الفارق الوحيد بين فرضية الفيلم هذه والواقع اليوم أن العالم تحكمه الشركات الاستهلاكية والإعلام الموجّه وفضلات السوشيال ميديا المدمّرة وليست مخلوقات فضائية.