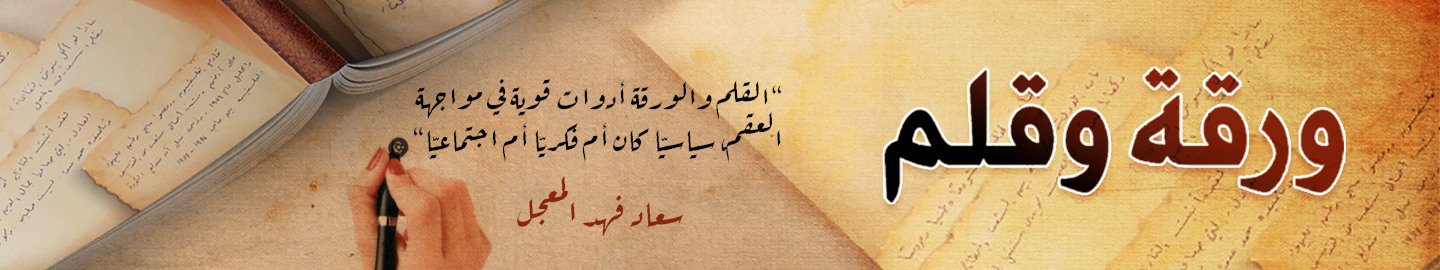فزّاعة الرقابة على النصوص

فزّاعة الرقابة على النصوص
في أجواء رمضانية مميزة جاءت دعوة الكنيسة لغبقة بعنوان “غبقة المحبة”، وبالفعل فقد حلّقت المحبة وتسلّقت أجواء الغبقة بحضور نيافة الأنبا أنطونيوس والقمص بيجول الأنبا بيشوي وأعضاء الكنيسة القبطية وحضور مُميّز من كل الطوائف والملل. وقد منحتني تلك الغبقة فرصة لقاء أحد أعمدة الفن والمسرح في الكويت والخليج، الفنان الكبير محمد المنصور، الذي يبدو أنه قد ألِفَ سؤال الناس له عن مصدر قسوته في مسلسل “نوح العين” الذي تعرضه عدة قنوات، حيث يظهر في أحد المشاهد وهو يحفر قبراً لوأد رضيعته بعد أن جاءت أنثى وليس ذكراً. كانت إجابة الفنان الكبير بأن علينا ألا نستبق الأحداث وننتظر بصبر تراكُم حبكة العمل.
الفن رسالة، والمسرح رائد في التوعية، هكذا تعلّمنا منذ الصغر، وإذا كان المسرح الكويتي قد قدّم وخدَم قضايا عديدة بشكل جيد، فإن هنالك محطات مهمة جداً لم يتطرّق لها بعد الفن أو المسرح في الكويت. سؤال لا شك يتبادر إلى ذهن كل منا عندما يلتقي بفنان بحجم وتاريخ محمد المنصور الذي يرى كما غيره من الفنانين أن معوقات كالرقابة على النصوص غالباً ما تُجهض أي محاولة جادة للخروج بعمل فني أو مسرحي يتطرّق إلى تلك المحطات الهامة من تاريخ الكويت.
هنالك دائماً جانبان من الفن، الجانب الترفيهي والجانب التوثيقي أو التوعوي، والاثنان لا شك مهمان، لكن المشكلة تأتي حين يطغى جانب على الآخر وبشكل يتحوّل معه العمل الفني أو المسرحي إما إلى تهريج وهزل، أو إلى جمود يفتقد للإبداع الجاذب للمُشاهد أو للمتابع.
تجربة المسرح الجاد في عالمنا العربي، بالتحديد، لا تزال تجربة محدودة بأعمالها وروادها، ففكرة المسرح الجاد أو أي شكل من الفنون الجدية تقوم أساساً على تقديم مضمون أو محتوى درامي بشكل جمالي وفلسفي وفكري، حيث خرج المسرح السريالي، والمسرح الرمزي وأيضا المسرح اللامعقول. للأسف لا تزال مثل هذه الأعمال أو المسرحيات بعيدة بعض الشيء عن ذائقه المشاهد العربي، ولا تزال التجربة في بدايتها، على الأقل بالنسبة للجمهور وليس على مستوى المبدعين من الفنانين الذين تجرؤوا على اقتحام عالم المسرح الجاد.
في المقابل، هنالك الفن أو المسرح الترفيهي، وهنا قد تكمن المشكلة، حيث يخلط البعض بين الترفيه والهزل أو التهريج. فهنالك قطعاً شروط للترفيه وإلا تحوّل العمل المسرحي أو الفني إلى نشاط لا هدف ولا دور له غير تسلية الناس وإمتاعهم، بغض النظر عن الأسلوب أو الوسيلة المُتّبَعَة.
الفن، كما ورد أعلاه، إذاً رسالة، وهو يحمل إلى جانب شقّه الترفيهي هدفاً وصوراً تعكس جوانب مختلفة من الحياة الواقعية، أو على الأقل هكذا يُفتَرَض. لكن في ظل أجواء الرقابة على النصوص، والحظر على بعض الحوادث والأحداث من التاريخ تكون حرية الفنانين مقيدة، وتهجر القريحة مُخَيّلتهم فيحدث أمر من اثنين، إما أن يفرض النسيان نفسه على النصوص المرفوضة أو المحظورة، أو أن يتحوّل المسرح والفن إلى مصدر رزق ووظيفة ويتم معها تجاهل المحتوى وبشكل ربما كان السبب الرئيسي وراء تدهور الحركة المسرحية والفنية ليس في الكويت وحدها، وإنما في العالم العربي بشكل عام. هنالك محطات ثرية في تاريخ الكويت بالإمكان طرحها ومعالجتها وتوثيقها فنياً ومسرحياً. فالكويت كانت حاضنة لأحداث سياسية وفكرية أثّرت في محيطها الإقليمي والعربي بشكل مباشر، من الفكر القومي العروبي، إلى حراك المشاركة السياسية، إلى التظاهرات الشعبية الداعمة والمؤيّدة لكل حركات التحرّر العربية، من الجزائر إلى اليمن، ومن سوريا إلى العراق، المجتمع الكويتي شهد حراكاً مجتمعياً مُمَيّزاً ذابت فيه الطوائف والأعراق المهاجرة أو القادمة من الشمال ومن الجنوب، ما أفرز نسيجاً ثرياً انعكس على العادات والملابس والغذاء، بل حتى اللهجة والمفردات.
ولا شك بأن مجتمعاً كهذا يكون ثرياً أيضاً وجاذباً للمادة وللنص الروائي والمسرحي والفني. لكن يبدو أن الموانع والمعوقات تَفَوّقَت هنا على حبكة المسرح والفن بشكل عام.
غالباً ما يَنص نظام الرقابة على الأعمال الفنية والمسرحية بكون النص خارجاً عن الآداب ومخالفاً لمصلحة الدولة العليا.
وهو بالتأكيد نص فضفاض ومطّاط وقابل للتأويل. آخر تلك المخالفات للنص كانت في منع المسرحية الجميلة “هذا سيفوه”، التي يبدو أنها جاءت بأكثر مما تتحمّله الدولة، إلى درجة أنه لم يتم حتى تسجيلها وتوثيقها، لكنها بقيت عالقة في ذاكرة من سنحَت له فرصة مشاهدتها.
فزّاعة الرقابة على النصوص هي التي أفرَزَت ما تعاني منه الحركة المسرحية والفنية من طرح هزيل وخاوٍ، فناً وأداءً. فبدلاً من التذمّر من سطحية الأعمال الدرامية، علينا أولاً أن نتحلّى بالجرأة ونقبَل بالنصوص الثرية المنسيّة والمحظورة.