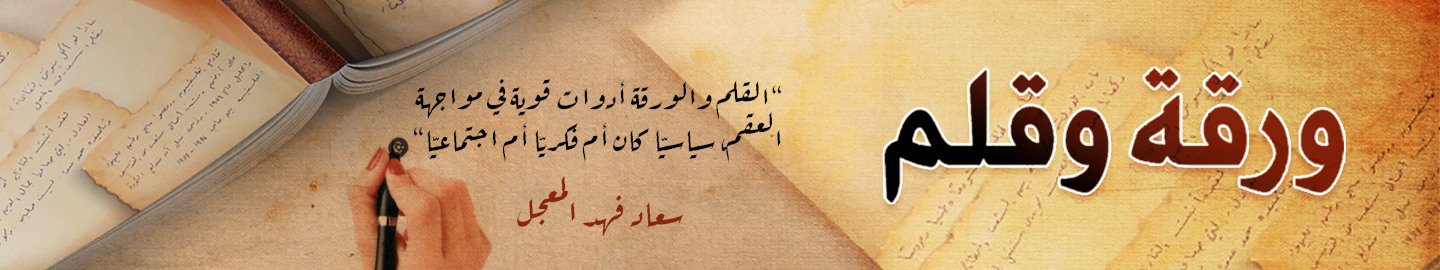تاريخ القراءة

تاريخ القراءة
للقراءة مفعول السحر على العقل والوجدان، فهي بمنزلة الخلوَة الروحانية والعقلية، وهي تمنح الإنسان رحلة سرمدية في غياهب العقل الأول، منبع الحقيقة والمعرفة والحكمة اللامتناهي، والمُمْتد عبر قصة الخَلْق والوجود.
جميعنا يقرأ لأسباب مختلفة، فالطالب يقرأ لكي ينجح، والعالِم يقرأ ليَستزيد علماً، والفضولي يقرأ ليُشْبع حيرته وفضوله، والمَلول يقرأ ليتسلى، وهكذا يستمر فِعل القراءة من دون انقطاع.
لم تؤثّر التكنولوجيا، كما يُروّج البعض، في شغف القراءة لمن يملكه، بل بالعكس فقد يسّرَت التكنولوجيا على القارئ سُبُل الحصول على الكتب بطرق مختلفة، وإن كان القراء التقليديون يتّهمونها – أي التكنولوجيا – بأنها قد شوّهَت صورة الكتاب وهيئته الحميمة التي توفّرها تلك العلاقة الحسّية بين القارئ وكتابه.
في كتاب للكاتب الأرجنتيني الأصل والكندي الجنسية “ألبرتو مانغويل” يَدخُل القارئ فيه عبر رحلة ثرية من التاريخ والأدب والفلسفة والشعر. الكتاب كما وصفه أحدهم يرد الاعتبار إلى الكتُب ويدفع القارئ إلى أن يلجأ إلى مكتبته للتّحقّق من جواهر قد يكون أغفلها في زحمة الأشياء وحركة الحياة.
يتحدث “مانغويل” عن القراءة بصوت عال، والقراءة بصمت، القراءة في الفراش أو تحت الشجر، يتحدّث عن تاريخ المكتبات ونشأة تصنيف الكتب، وعن تدرّج الكتابة من الصلصال، إلى البردي وإلى الرق. يتناول تاريخ أشهر المكتبات، وأشهر الشعراء والمفكرين ورواة القصة في مرحلة ممتدة منذ أكثر من ألفي عام قبل الميلاد، وإلى مرحلتنا الراهنة.
الكتاب يقع في 384 صفحة، به من التشعّب والانسجام في الوقت نفسه ما قد يُلهم القارئ في ما بعد للبحث في ما ورَدَ فيه من أحداث وقصص وروايات تمتد طويلاً في تاريخ البشرية، لكن وصفه للعلاقة بين الكاتب والقارئ يتفوّق على كل ما طُرِح في السابق بشأن تلك العلاقة، فهو يعود بهذه العلاقة إلى بداية فِعْل الكتابة، حيث كان الهدف من وضع الرموز على الصلصال هو حفظ المعلومة وعدم الاعتماد على ذاكرة إنسان معين، أو استدعاء لصاحب هذه الذاكرة عند الرغبة في الاطلاع على هذه المعلومة. وكَفِعل السحر، استطاعت تلك الأشياء المعنوية المدوّنة على الصلصال، سواء كانت أعداداً أو أفكاراً، أن تنتقل عبر الزمان والمكان من دون حاجة إلى مراسل، ومن دون عَقَبات جغرافية.
ويسترسل “مانغويل” في شرح هذه العلاقة، حيث يقول إن أمراً آخر قد تم اكتشافه بفضل فِعل الكتابة، التي وإن كان هدفها المحافظة على نص من الضياع، فإنه قد أدى كذلك إلى عملية خَلْق القارئ، فالكاتب الذي كان يُعِد الرسائل ويَخلق العلاقات، اتضح أنه بحاجة إلى مُتَلقّ أو شخص آخر يستطيع قراءتها وإعطاء الرسائل صوتاً تُنطَق به، بمعنى آخر، إن الكتابة كانت بحاجة ماسّة إلى القارئ.
يسترسل الكاتب في شرح تلك العلاقة التفاعلية بين الكاتب والقارئ، ليؤكّد أن الاكتشاف غير العادي للكلمة المكتوبة مع كل فهارسها ورسائلها وقوانينها وآدابها قد اعتمَدَ على مهارة الكاتب في استرجاع النص من أجل قراءته. وهنا يَستعير وصف أحد الشعراء للكارثة التي تَحل بالحضارة عندما تفقد قُرّاءها، فالقارئ كما يراه العديد من المفكرين والمبدعين والكُتّاب شريك في عملية الخَلْق هنا، فالقارئ يكتب النص بالكلمات الأصلية نفسها، لكن بأفكار أخرى، خالقاً إياه من جديد وذلك بالتقاطه من صفحات الكتاب وبَعث الحياة فيه.
قديماً، وقبل أن يخترع يوهان غوتنبرغ فكرة الطباعة، كانت القراءة مُكلِفة، وكان فن القراءة والكتابة مقصوراً على الطبقة الارستقراطية والثرية، بل إنها في بلاد الرافدين كانت تُمارَس من قِبَل الرجال فقط وبالتحديد أصحاب السلطة، لذلك فإن الفرق بين إمكانات القارئ آنذاك واليوم لربما يُقاس بسنوات ضوئية، وإذا ما كان فِعْل القراءة تراجَعَ في مجتمعاتنا لأسباب تَتَعلّق بتأخّرنا الثقافي والتعليمي والفكري والأدبي، فإن القراءة تبقى هي مفتاح المعرفة، وطريق الحكمة.
وإذا كان الكاتب يوفّر طاقة لفكرة أو رؤية أو أدب أو شعر، فإن القارئ هو السُّلطة التنفيذية لِفِعْل الكتابة هذا.